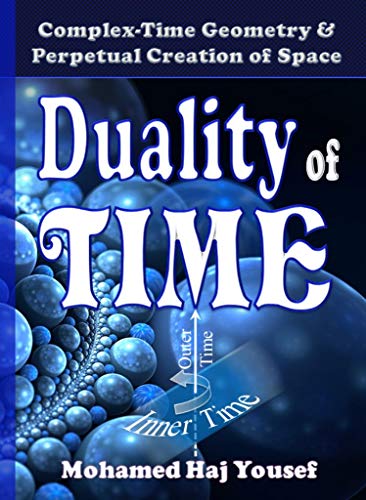به الغذاء للجسم و لكن لا يشعر به كثير من الناس إلا العلماء بعلم الطبيعة و ذلك أعني صورة قوله ﴿أُكُلُهٰا دٰائِمٌ﴾ إن الإنسان إذا أكل الطعام حتى يشبع فذلك ليس بغذاء و لا بأكل على الحقيقة و إنما هو كالجاني الجامع مع المال في خزانته و المعدة خزانة لما جمعه هذا الآكل من الأطعمة و الأشربة فإذا جعل فيها أعني في خزانة معدته و ما اختزنه فيها و رفع يده حينئذ تتولاها الطبيعة بالتدبير و ينتقل ذلك الطعام من حال إلى حال و يغذيه بها في كل نفس يخرج عنه دائما فهو لا يزال في غذاء دائم و لو لا ذلك لبطلت الحكمة في ترتيب نشأة كل متغذ و اللّٰه حكيم فإذا خلت الخزانة حرك الطبع الجابي إلى تحصيل ما يملؤها به فلا يزال الأمر هكذا دائما أبدا فهكذا صورة الغذاء في المتغذي فالتغذي في كل نفس دنيا و آخرة و كذلك أهل النار و قد وصفهم اللّٰه بالأكل و الشرب فيها على هذا الحد إلا أنها دار بلاء فيأكلون عن جوع و يشربون عن عطش و أهل الجنة يأكلون و يشربون عن شهوة لالتذاذ لا عن جوع فإنهم ما يتناولون الشيء المسمى غذاء إلا عن علم بأن الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرغ ما كان مختزنا فيه فيسارع إلى الطبيعة بما تدبره فلا يزال في لذة و نعيم لا يحوج الطبيعة إلى طلب و حاجة للكشف الذي هم عليه كما إن أهل النار في الحجاب فلا يعلمون هذا القدر فيجوعون و يظمئون لأن المقصود منهم أن يتألموا فتبين لك أنه لا لذة إلا العلم و لا ألم إلا الجهل و الشمس مكورة قد نزع نورها في أعينهم طالعة على أهل النار و غاربة كما تطلع على أهل الدنيا في حال كسوفها و كذلك القمر يسبحان و جميع الدراري على صورة سباحتهم الآن في أفلاكهم لكنها مطموسة في أعينهم فعلى ما هو الأمر في نفسه هم الذين طمس اللّٰه أعينهم إذ شاء عن إدراك الأنوار التي في المنبرات فالحجاب على أعينهم كما نعلم أن الشمس هنا في حال كسوفها ما زال نورها منها و إنما القمر حجبها عنا و لو لم يكن كذلك ما عرف أهل التعاليم متى يكون الكسوف و كم يذهب منها في الكسوف عن أعيننا و يقع ذلك على ما ذكروه فلو كان من الأمور التي لا تجري على مقادير موضوعة و موازين محكمة قد أعلمها اللّٰه من و فقه لطلب مثل هذا العلم ما علمه و هذا لا يقدح في قولنا إن الشمس قد كسفت أو قد زال نورها عن إدراك أعيننا فإن هذا القدر و هذه الصورة ما ثم من يمنعنا أن نصطلح على أن نطلق عليها اسم كسوف و خسوف و تكوير و طمس فيشهد أهل النار أجرام السيارة طالعة عليهم و غاربة و لا يشهدون لها نورا لما في الدخان من التطفيف فكما كانوا في الدنيا عمياء عن إدراك أنوار ما جاءت به الشرائع من الحق كذلك هم في النار عمي عن إدراك أنوار هذه السيارة و غيرها من الكواكب ﴿وَ مَنْ كٰانَ فِي هٰذِهِ أَعْمىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمىٰ وَ أَضَلُّ سَبِيلاً﴾ [الإسراء:72] و إنما كان أضل سبيلا فإنه في الدنيا يجد من يرشده إلى الطريق و لكن لا يسمع و في النار ما يجد من يرشده إلى الطريق فإنه ما ثم طريق لكن يجد من يندمه على ما فاته ليزيده حسرة إلى حسرته و عذابا إلى عذابه فليل أهل النار لا صباح له و نهار أهل الجنة لا مساء له أي لا ليل فيه فمن وعظ الناس في عقده طلبا منه بذلك أن ينفع الناس في عقده فما عرف اللّٰه بخلاف المذكر فإنه يذكر و يعظ بما عنده و يعلم أن من السامعين من يكون له ذلك الوعظ شفاء و دواء و من الناس من يزيده مرضا إلى مرضه كما قال تعالى ﴿وَ إِذٰا مٰا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ﴾ [التوبة:124] و هي واحدة ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزٰادَتْهُمْ إِيمٰاناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [التوبة:124] بورود العافية عليهم ﴿وَ أَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزٰادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة:125] و السورة واحدة و المزاج مختلف فلا يعرف حقيقة هذه الآية إلا الأطباء الذين يعلمون أن العقار الفلاني فيه شفاء لمزاج خاص من مرض خاص و هو داء و علة لمزاج خاص و زيادة مرض في مرض خاص فالطبيب أحق الناس علما بهذه الآية و كذلك طبيب القلوب فيما يؤمنها و يخيفها فالحكيم هو الذي يأتي إلى العليل من ما منه و يظهر له بصورة من يعتقد فيه ليستدرجه إلى صورة الحق بالحق الذي يليق به و لكن وقع الأمر الإلهي في العالم بخلاف هذا لأن مشيئة اللّٰه تعلقت بأن اللّٰه لا يجمعهم على الهدى و أما الطريق في ذلك فمعلوم عند اللّٰه و عند أهله لا يشكون فيه فإن الذي يعتقد في مخلوق ما من حجر أو نبات أو حيوان أو كوكب إنه إلهه و هو يعبده و يخاطبه ذلك الإله المشهود له على الكشف بما هو الحق عليه يرجع إلى قوله لاعتقاده فيه كما يرجع إلى قوله في الآخرة و يتبرأ منه كما تبرأ إلهه منه و اللّٰه قادر على أن ينطقه في الدنيا بذلك في حق من يعبده لكن العلم السابق و المشيئة الإلهية منعا من ذلك ليكون الخلاف في العالم فجرى الأمر على ذلك في الدنيا و بعض