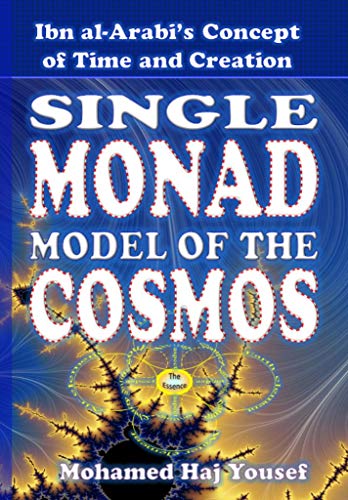الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية) |
||
| الباب: | فى حال قطب كان منزله (أفوض أمرى إلى اللّه) | |
|
بأدبه فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم والشر ليس إليك ومن كونه خلقا يحس بالألم الحسي والنفسي كما يحس باللذات المحسوسة والمعنوية ويعلم الفرقان بينهما وأن السرور يصحب الالتذاذ وأن الحزن يصحب الألم طبعا فلذلك عدل في الضراء إلى حمد الله على كل حال والأحوال في العالم ما هي بأمر زائد على الشأن الذي ألحق فيه بل هو عين الشأن كل حال يطرأ في الوجود مما يوافق الغرض ويلائم الطبع ومما لا يوافق الغرض ولا يلائم الطبع وإن كان الأمر في ذلك من القابل لأنا رأينا ما يتضرر به زيد يلتذ به عمر وفعلمنا إن العلة في القابل وأن الأمر الآتي منه تعالى واحد العين لا انقسام فيه فينقسم فينا أمره ويتعدد ولما عم هذا الذكر جميع الأحوال فإن تحقق الذاكر الله به ما وضع له فهي دعوى فإن الله لا بد أن يبتلي الشخص الذي يذكر الله بهذا الذكر على هذا الحد فإن الدعوى تفتح باب الابتلاء في القديم والحديث إن فهمت وإن كان الذاكر به ما خطر له أصل وضعه بخاطر بل ذكر الله به لكونه مشروعا من غير وقوف مع السبب في وجوده وتشريعه فقد يبتليه الله وقد لا يبتليه وإن قيده هذا الذاكر أعني ذلك الذكر بأنه ثناء على الله لجهة الخير لا يقصد به أصل وضعه ولا يقوله بدعوى إنه الحامد ربه على كل حال وإنما يقول ذلك مخبرا أن الله محمود على كل حال فإنه ما من حال كما قررناه إلا وله وجه في الخلق إلى الالتذاذ به والتألم به فما من حال إلا ويحمد الله عليه حمد سراء وحمد ضراء أ لا تراه في السراء كيف يقول الحمد لله المنعم المفضل فمن إنعامه وفضله إن جعل صاحب الضراء يحمد الله ولهذا يعافيه ويحول بينه وبين تلك الضراء لأن حمده شكر على هذا الإفضال وهو أن ألهمه واستعمله في حمد الله ولم يستعمله في الضجر والسخط فعافى باطنه بما ألهمه إليه من التحميد فزاده الله عافية بإزالة الضراء عنه وهذا معنى دقيق مندرج في الحمد لله على كل حال وإنه مساو لحمد السراء وهو الحمد لله المنعم المفضل وبزيادة وهذا من جوامع الكلم التي أوتيها رسول الله صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم وتختلف أحوال الذاكرين الله بهذا التحميد فكل حامد به ينتج له بحسب قصده وعلمه وباعثه وقد فصلناه تفصيلا كما أنزله الحق عز وجل في قلوب الذاكرين الله به تنزيلا فهو حمد سراء وحمد ضراء والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ «الباب التاسع والستون وأربعمائة في حال قطب كان منزله وأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله»إن الوجود منطق ومنطق *** ومصدق ومصدق فتفكروا فالشيء يكذب نفسه فمكذب *** ومكذب والعين لا تتكثر فلأي شيء يرجع الأمر الذي *** قد قلته في أمرنا فتبصروا حتى تروه بالعيان ففوضوا *** أمر الوجود إليه لا تتحيروا [ليس في وسع المخلوق أن يحمله يحمله الله]قال الله عز وجل لنبيه صَلَّى اللهُ عَليهِ وسَلَّم أن يقول لقومه حين ردوا دعوته فَسَتَذْكُرُونَ ما أَقُولُ لَكُمْ وأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله وهو من فاض ولا يفيض حتى يمتلئ فالفيض زيادة على ما يحمله المحل وذلك أن المحل لا يحمل إلا ما في وسعه أن يحمله وهو القدر والوجه الذي يحمله المخلوق وما فاض من ذلك وهو الوجه الذي ليس في وسع المخلوق أن يحمله يحمله الله فما من أمر إلا وفيه للخلق نصيب ولله نصيب فنصيب الله أظهره التفويض فينزل الأمر جملة واحدة وعينا واحدة إلى الخلق فيقبل كل خلق منه بقدر وسعه وما زاد على ذلك وفاض انقسم الخلق فيه على قسمين فمنهم من جعل الفائض من ذلك إلى الله تعالى فقال وأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله وينسب ذلك الأمر إلى نفسه لأنه لما جاءه ما تخيل أنه يفضل عنه وتخيل أنه يقبله كله فلما لم يسعه بذاته رده إلى ربه ومنهم من لم يعرف ذلك فرجع الفائض إلى الله من غير علم من هذا الذي حصل منه ما حصل فهو إلى الله على كل وجه وما بقي الفضل إلا فيمن يعلم ذلك فيفوض أمره إلى الله فيكون له بذلك عند الله يد ومنهم من لا يعلم ذلك فليس له عند الله بذلك منزلة ولا حق بتوجه قال تعالى قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ [فإن العبد محل لظهور أثر كل اسم إلهي الذي قابل أن تحمله]واعلم أن العبد القابل أمر الله لا يقبله إلا باسم خاص إلهي وأن ذلك الاسم لا يتعدى حقيقته فهذا العبد ما قبل الأمر إلا بالله من حيث ذلك الاسم فما عجز العبد ولا ضاق عن حمله فإنه محل لظهور أثر كل اسم إلهي فعن الاسم الإلهي فاض لا عن العبد فلما فوضه بقوله وأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى الله ما عين اسما بعينه وإنما فوضه إلى الاسم الجامع فيتلقاه منه ما يناسب ذلك الأمر من الأسماء في خلق آخر فإنه ما لا يحمله زيد وضاق عنه لكون الاسم الإلهي الذي قبله به ما أعطت حقيقته إلا ما قبل منه وقد يحمله عمر ولأنه أوسع من زيد بل لا أنه أوسع من زيد ولكن عمرو في حكم اسم أيضا إلهي قد يكون أوسع إحاطة من الاسم الإلهي الذي كان عند زيد فإن الأسماء الإلهية تتفاضل في العموم والإحاطات فيحيط العالم ويحيط العليم فيكون إحاطة العليم أكثر من إحاطة العالم وإحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيره وكذلك الاسم المريد مع العالم والاسم القادر مع المريد ومع العالم تقل إحاطته عنهما والعبد لا بد أن يكون تحت حكم اسم إلهي فهو بحسب ذلك الاسم وما تعطيه حقيقته من القبول فيرد ما فضل عنه إليه تعالى وذلك التفويض لمن عقل عن الله قوله فإن اللسان الذي خاطبنا به الحق اقتضى ذلك فنحن معه بقوله لأنه ليس في وسع المخلوق أن يحكم على الخالق إلا من يكون شهوده ما هي الممكنات عليه في حال عدمها فيرى أنها أعطت العلم للعالم بنفسها فقد يشم من ذلك رائحة من الحكم لكن افتقارها من حيث إمكانها يغلب عليها ولهذا ترى النافين للإمكان بالدلالة العقلية يغفلون في أكثر الحالات عما أعطاهم الدليل من نفي الإمكان في نفس الأمر فيقولون بالإمكان حتى يراجعوا وينبهوا فيتذكروا ذلك فلا بد من أمر يكون له سلطنة في هذا العبد حتى يتصف بالغفلة والذهول عما اقتضاه دليله وليس إلا الأمر الطبيعي والمزاج أ لا تراه إذا انتقل بالموت الأكبر أو بالموت الأصغر إلى البرزخ كيف يرى في الموت الأصغر أمورا كان يحيلها عقلا في حال اليقظة وهي له في البرزخ محسوسة كما هي له في حال اليقظة ما يتعلق به حسه فلا ينكره فيما كان يدل عليه عقله من إحالة وجود أمر ما يراه موجودا في البرزخ ولا شك أنه أمر وجودي تعلق الحس به في البرزخ فاختلف الموطن على الحس فاختلف الحكم فلو كان ذلك محالا لنفسه في قبول الوجود لما اتصف بالوجود في البرزخ ولما كان مدركا بالحس في البرزخ بل قد يتحقق بذلك أهل الله حتى يدركوا ذلك في حال يقظتهم ولكن في البرزخ فهم في حال يقظتهم كحال النائم والميت في حال نومه وموته فإن تفطنت فقد رميت بك على طريق العلم بقصور النظر العقلي وإنه ما أحاط بمراتب الموجودات ولا علم الوجود كيف هو إذ لو كان كما حكم به العقل ما ظهر له وجود في مرتبة من المراتب وقد ظهر فليس لعاقل ثقة بما دله عليه عقله في كل شيء فإذا كان صحيح الدلالة سرى ذلك في كل صورة فيعلم في كل صورة يراها في البرزخ وتحصل في نفسه أنه الله فهو الله فما يختلف كونه وإن اختلفت صور تجليه وكذلك عند العارفين به هنا ما يختل عليهم شيء من ذلك ولا في البرزخ ولا في القيامة الكبرى فيشهدون ربهم في كل صورة من أدنى وأعلى وكما هم اليوم كذلك يكونون غدا وأما أبو يزيد فخرج عن مقام التفويض فعلمنا أنه كان تحت حكم الاسم الواسع فما فاض عنه شيء وذلك أنه تحقق بقوله ووسعني قلب عبدي فلما وسع قلبه الحق والأمور منه تخرج التي يقع فيها التفويض ممن وقع فهو كالبحر وسائر القلوب كالجداول وقال في هذا المقام لو أن العرش يريد به ما سوى الله وما حواه مائة ألف ألف مرة يريد الكثرة بل يريد ما لا يتناهى في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحس به يعني لاتساعه حيث وسع الحق ومن هنا قلنا إن قلب العارف أوسع من رحمة الله لأن رحمة الله لا تنال الله ولا تسعه وقلب العبد قد وسعه إلا إن في الأمر نكتة أومئ إليها ولا أنص عليها وذلك أن الله قد وصف نفسه بالغضب والبطش الشديد بالمغضوب عليه والبطش رحمة لما فيه من التنفيس وإزالة الغضب وهذا القدر من الإيماء كاف فيما نريد بيانه من ذلك فإن الرسل تقول ولن يغضب بعده مثله فالانتقام رحمة وشفاء ولو لا كونه رحمة ما وقع في الوجود وقد وقع ولكن ينبغي لك أن تعلم بمن هو وقوع الانتقام رحمة فبان لك من هنا رتبة أبي يزيد من غيره من العارفين لأنه وأمثاله لا يتكلمون إلا عن أحوالهم وذوقهم فيها ومن أسمائه تعالى الواسع كما ورد فباتساعه قبل الغضب فلو ضاق عنه ما ظهر للغضب حكم في الوجود لأنه لم يكن له حقيقة إلهية يستند إليها في وجوده وقد وجد فلا بد أن ينسب الغضب إلى الله كما يليق بجلاله وقد وسع القلب الحق ومن صفاته الغضب فقد وسع الغضب فلا ينكر على العارف مع كونه ما يرى إلا الله أن يغضب ويرضى ويتصف بأنه يؤذي وإن لم يتأذ فما أذى من لا يتأذى غير أنه لا يقال ذلك في الجناب الإلهي إلا أنه تسمى بالصبور وأعلمنا بالصبر ما هو وعلى ما ذا يكون ولا نقول هو في حق الحق حلم فإن الحليم |