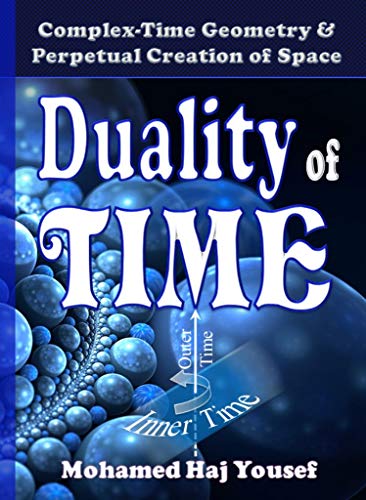الفتوحات المكية - طبعة بولاق الثالثة (القاهرة / الميمنية) |
||
| الباب: | فى معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام الجمع من الحضرة المحمدية | |
|
له لا من كونها معذبة به والوجه الجامع بين المسألتين وجود الحكم المضاف إلى المعنى في غير المحل الذي قام به ذلك المعنى وهل العلم مثل الإرادة في هذا الباب وغيره من الصفات أم لا فيقوم العلم بزيد ولا يعلم به زيد ويعلم به عمر وهذا محال عقلا ولكن هذا المنزل يحكم بوقوع ذلك فإن أردت تأنيس النفس لقبول ما أعطاه هذا المنزل في هذه المسألة فانظر ما أنت مجمع عليه مع أصحابك إن الحق سبحانه يتعالى عن الحلول في الأجسام فإن الإنسان إنما يبصر ببصره القائم بجارحة عينه في وجهه ويسمع بسمعه القائم بجارحة أذنه ويتكلم بالكلام الموجود في تحريك لسانه وتسكينه وشفتيه ومخارج حروفه من صدره إلى شفتيه ثم إن هذا الشخص يعمل بطاعة الله تعالى الزائدة على فرائضه من نوافل الخيرات فينتج له هذا العمل نفي سمعه وبصره وكلامه وجميع معانيه من بطش وسعي التي كانت توجب له أحكامها فكان ينطلق عليه من أحكامها سميع بصير متكلم إلى غير ذلك فصار يسمع بالله بعد ما كان يسمع بسمعه ويبصر بالله بعد ما كان يبصر ببصره مع العلم بأن الله يتقدس أن تكون الأشياء محلا له أو يكون هو محلا لها فقد سمع العبد بمن لم يقم به وأبصر بما لم يقم به وتكلم بما لم يقم به فكان الحق سمعه وبصره ويده فهكذا وجود العذاب في المحال التي لم تقم بها الصفة التي يكون حكمها العذاب كما قد ثبت أن الصفة تعطي خلاف حكمها في المحل وأنت القائل به ولا فرق بين المسألتين وقد أنشد في ذلك صاحب محاسن المجالس فهل سمعتم بصب *** سليم طرف سقيم منعم بعذاب *** معذب بنعيم وأنشد أبو يزيد الأكبر طيفور بن عيسى البسطامي يخاطب ربه عز وجل أريدك لا أريدك للثواب *** ولكني أريدك للعقاب وكل ما ربي قد نلت منها *** سوى ملذوذ وجدي بالعذاب فطلب اللذة في العذاب وهذا عكس الحقائق في العقل ولكن أهل الكشف والذوق وجدوا أمورا أحالها العقل وإن كنا نعرف نحن ما قاله القائلان في شعرهما ومن هذا الباب قال الله للنار كُونِي بَرْداً وسَلاماً والنار لا تكون بردا في العقل إذ لو كانت بردا لبطلت الحقائق أن تكون حقائق فقد جاء الذوق في تجليه بخلاف ما يعطيه العقل وإن كنا نحن نعرف ما قاله الحق في ذلك ولمن خاطب به ولكن جئنا بذلك تأنيسا للمريد ليتحقق أَنَّ الله عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأن قدرته مطلقة على إيجاد المحال لو شاء وجوده كما ذكره في كتابه عن نفسه ما هو محال في العقل بما يعطيه دليله فقال لَوْ أَرادَ الله أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى مِمَّا يَخْلُقُ ما يَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ الله الْواحِدُ الْقَهَّارُ فألحقه بدرجة الإمكان بالنسبة إلى المشيئة الإلهية والعقل قد دل على إن ذلك محال لا من كونه لم يرده فكانت هذه الآية أولها جرح جرح به العقل في صحة دليله ليبطله ثم داوى ذلك الجرح في آخر الآية بقوله سبحانه أي هو المنزه أن يكون لأحديته ثان غير أن في قوله القهار أسرارا من اعتبرها لمن يكون قهارا وجميع الأفعال إنما هي أحكام أسمائه في الكون فلا فعل لأحد إلا لله فالأفعال كلها من الاسم القادر والقاهر فما يقهر بالاسم القاهر إلا موجد ذلك الفعل في الكون وهو أثر القاهر فما قهر إلا نفسه وهو أثر الاسم القادر فما قهر إلا الاسم القادر وهو المشارك له في وجود العين فما قهر القاهر القادر إلا بالاسم القادر فالقادر نفسه قهر بالاسم القاهر إلا أن يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد فيكون عند ذلك القهر مضافا إلى الاسم المريد ولكن ما يمنع إلا بالاسم القاهر للعين التي تهيأت لقبول الوجود فقهرتها المشيئة وأخرتها عن الوجود لأن لها الترجيح فقد حصلت لك بما أوردته من الأنس في قبول هذه المسألة ما فيه كفاية فيما تعطيه طريقة القوم والله يَقُولُ الْحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ «الباب الأحد والثمانون ومائتان في معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام الجماعة من الحضرة المحمدية»صلاة العصر ليس لها نظير *** لنظم الشمل فيها بالحبيب هي الوسطى لأمر فيه دور *** محصلة على أمر عجيب وما للدور من وسط تراه *** ولا طرفين في علم اللبيب فكيف الأمر فيه فدتك نفسي *** فخص العبد بالعلم الغريب [قلب العبد حيث ماله]قال رب هذا المنزل إن الصلاة الوسطى أجرها مقرون إذا لم تصل في جماعة بأجر من وتر أهله وماله وقد قال العدل عيسى عليه السلام قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبكم في السماء أي تصدقوا وإلى هنا انتهت معرفة هذا العدل وقال الصادق المؤتي جوامع الكلم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الصدقة تقع بيد الرحمن فيربيها فيكون قلب العبد حيث ماله وإن حيثيته يد الرحمن وأين يد الرحمن من السماء فقد أجمع العدلان على إن المال له من القلب مكانة علية وأما الأهل من زوج وولد فلا خفاء على ذي لب أنهم منوطون بالفؤاد فأما الزوجة فقد جعل الله بينها وبين بعلها المودة والرحمة والسكون إليها والسكون صفة مطلوبة للأكابر وهي الطمأنينة قال إبراهيم بَلى ولكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي أي يسكن إلى الوجه الذي يحيي به الموتى ويتعين لي إذ الوجوه لذلك كثيرة فسكن إليه سكونا لا يشوبه تحير ولا تشويش يعني في معرفة الكيفية فانظر بما ذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر وسبب ذلك أن أوائل أوقات الصلوات الأربع محدودة إلا العصر فإنها غير محدودة وإن قاربت الحد من غير تحقيق فقربت من التنزيه عن تقييد الحدود إذ كان المغرب محدودا بغروب الشمس وهو محقق محسوس والعشاء محدود أوله بمغيب الشفق وهو محقق محسوس أي شفق كان على الخلاف المعلوم فيه والفجر محدود أوله بالبياض المعترض في الأفق المستطير لا المستطيل وهو محقق محسوس والظهر محدود بزوال الشمس وفيء الظل وهو محقق محسوس ولم يأت مثل هذه الحدود في العصر فتنزهت عن الحدود المحققة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم وقتها أن تكون الشمس مرتفعة بيضاء نقية والحد الوارد في ذلك ما يكون في الظهور مثل سائر حدود أوقات الصلوات فعظم قدرها النبي صلى الله عليه وسلم للمناسبة في نفي تحقيق الحدود وكذلك حب المال والأهل لا يضبطه حد يقول القائل في الولد وإنما أولادنا بيننا *** أكبادنا تمشي على الأرض فأنزل الولد منزلة النفس وكما لا يفنى الإنسان في حبه نفسه للقرب المفرط الذي ما يكون مثله قرب إليه البتة كذلك لا يفنى الإنسان في حب ولده ولا ماله ولا أهله لأنه منوط بقلبه بمنزلة نفسه للقرب المفرط يخفى ذلك فيه فإن اتفق أن يطلق امرأته وقد كان حبه إياها كامنا فيه لا يظهر لإفراط القرب أخذه الشوق إليها وهام فيها وحن إليها لبعدها عن ذلك القرب المفرط لتعلق الشوق والوجد بها ولهذا يفنى العاشق في معشوقه الأجنبي لأنه ليس له ذلك القرب الظاهر الذي يحول بينه وبين الاشتياق إليه ولقرب الحق من قلوب العارفين بالعلم المحقق الذوقي الذي وجدوه لهذا صحوا ولم يهيموا فيه هيمان المحبين لله من كونه تجلى لهم في جمال مطلق وتجليه للعلماء به في كمال مطلق وأين الكمال من الجمال فإن الأسماء في حق الكامل تتمانع فيؤدي ذلك التمانع إلى عدم تأثيرها فيمن هذه صفته فيبقى منزها عن التأثير مع الذات المطلقة التي لا تقيدها الأسماء ولا النعوت فيكون الكامل في غاية الصحو كالرسل وهم أكمل الطوائف لأن الكامل في غاية القرب يظهر به في كمال عبوديته مشاهدا كمال ذات موجدة وإذا تحققت ما قلناه علمت أين ذوقك من ذوق الرجال الكمل الذين اصطفاهم الله فيه واختارهم منه ونزههم عنه فهم وهو كهو وهم فسماه الكامل منهم العصر لأنه ضم شيء إلى شيء لاستخراج مطلوب فضمت ذات عبد مطلق في عبوديته لا يشوبها ربوبية بوجه من الوجوه إلى ذات حق مطلق لا يشوبها عبودية أصلا بوجه من الوجوه من اسم إلهي بطلب الكون فلما تقابلت الذاتان بمثل هذه المقابلة كان المعتصر عين الكمال للحق والعبد وهو كان المطلوب الذي له وجد العصر فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد سعدت وألقيتك على مدرجة الكمال فارق فيها ولهذا المعنى الإشارة في نظمنا في أول الباب صلاة العصر ليس لها نظير *** لضم الشمل فيها بالحبيب وبعد أن أبنت لك مرتبة الكمال فلنبين لك من هذا المنزل قيام الواحد مقام الجماعة وهو عين الإنسان الكامل فإنه أكمل من عين مجموع العالم إذ كان نسخة من العالم حرفا بحرف ويزيد أنه على حقيقة لا تقبل التضاؤل حين قبلها أرفع الأرواح الملكية إسرافيل فإنه يتضاءل في كل يوم سبعين مرة حتى يكون كالوضع أو كما قال والتضاؤل لا يكون إلا عن رفعة سبقت ولا رفعة للعبد الكلي في عبوديته فإنه مسلوب الأوصاف فلو أنتج لذلك الروح المتضايل حال هذا العبد الكلي في عبوديته لما تكرر عليه التضاؤل فافهم ما أشرت به إليك وقد نبهتك بهذا الخبر أن هذا الملك من أعلم الخلق بالله وتكرار تضاؤله لتكرار التجلي والحق لا يتجلى في صورة مرتين فيرى في كل تجل ما يؤديه إلى ذلك التضاؤل هذا هو العلم الصحيح الذي تعطيه معرفة الله ثم لتعلم إن الله خلق الْإِنْسانَ في أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ للصورة التي خصه بها وهي التي أعطته هذه المنزلة فكان أحسن تقويم في حقه لا عن مفاضلة أفعل من كذا بل هو مثل قوله الله أكبر لا عن مفاضلة بل الحسن المطلق للعبد الكامل كالكبرياء المطلق الذي للحق فهو أحسن تقويم لا من كذا كما هو الحق أكبر لا من كذا لا إله إلا هو ولا عبد إلا المصمت في عبودته فإن حاد العبد عن هذه المرتبة بوصف ما رباني وإن كان محمودا من صفة رحمانية وأمثالها فقد زال عن المرتبة التي خلق لها وحرم من الكمال والمعرفة بالله على قدر ما اتصف به من صفات الحق فليقلل أو يكثر [أن للإنسان حالتين حالة عقلية نفسية مجردة عن المادة وحالة عقلية نفسية مدبرة للمادة]واعلم أن للإنسان حالتين حالة عقلية نفسية مجردة عن المادة وحالة عقلية نفسية مدبرة للمادة فإذا كان في حال تجريده عن نفسه وإن كان متلبسا بها حسا فهو على حالته في أحسن تقويم وإذا كان في حال لباسه المادة في نفسه كما هو في حسه فهو على حالته في خسر لا ربح في تجارته فيه فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وما كانُوا مُهْتَدِينَ وهو قوله إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ إِنَّ الْإِنْسانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ إِنَّ الْإِنْسانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا فإذا قال الإنسان الكامل الله نطق بنطقه جميع العالم من كل ما سوى الله ونطقت بنطقه أسماء الله كلها المخزونة في علم غيبه والمستأثرة التي يخص الله تعالى بمعرفتها بعض عباده والمعلومة بأعيانها في جميع عباده فقامت تسبيحته مقام تسبيح ما ذكرته فأجره غَيْرُ مَمْنُونٍ وسنومئ إلى تحقيق هذا في المنزل التاسع والثمانين ومائتين وبعد أن نبهتك على معرفة قيام التوحيد بالواحد القائم مقام الجماعة في الخير والشر فإنه قال تعالى في هذا المقام في الخير والشر من قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ومن أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ومنزلتنا في هذا البيان لأصحابنا من أهل هذا الشأن ومنزلة القابلين لما بيناه وغير القابلين ما أردف الله به هذه الآية من تعريف الأحوال فقال ولَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُنا بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ في الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ فلنبين إيمان العصاة المعبر عنه بالتوبة وما يلزمه وذلك أن الايمان الأصلي هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها وهو شهادتهم له سبحانه بالوحدانية في الأخذ الميثاقي فكل مولود يولد على ذلك الميثاق ولكن لما حصل في حصر الطبيعة بهذا الجسم محل النسيان جهل الحالة التي كان عليها مع ربه ونسيها فافتقر إلى النظر في الأدلة على وحدانية خالقه إذا بلغ إلى الحالة التي يعطيها النظر وإن لم يبلغ هذا الحد فإن حكمه حكم والدية فإن كانا مؤمنين أخذ بتوحيد الله تعالى منهم تقليدا وإن كانا على أي دين كان ألحق بهما فمن كان إيمانه تقليدا جزما كان أعصم وأوثق في إيمانه ممن أخذه عن الأدلة لما يتطرق إليها إن كان حاذقا فطنا قوي الفهم من الحيرة والدخل في أدلته وإيراد الشبه عليها فلا يثبت له قدم ولا ساق يعتمد عليها فيخاف عليه فإذا تقدم إيمانه بتوحيد الله شرك ورثه عن أبويه أو عن نظره أو عن الأمة التي هو فيها فذلك الايمان هو عين إيمانه الميثاقي لا غيره وإنما حال بينه وبين العبد حجاب الشرك كالسحابة الحائلة بين البصر والشمس فإذا انجلت ظهر الشمس للبصر كذلك ظهور الايمان للعبد عند ارتفاع الشرك إذ كان المشرك مقرا بوجود الحق فإن قلت فما حكم المعطل هل يكون إيمانه يوجد في الوقت أم حاله حال المشرك قلنا المعطل أقرب إلى الايمان من المشرك فإنه لا بد لكل إنسان أن يجد نفسه مستندا في وجوده إلى أمر ما لا يدري ما هو فيقال له ذلك هو الله فإن حدث له بعد ذلك هل هو واحد أو أكثر من واحد كان في محل النظر في ذلك أو يقلد من يعتقد فيه من الموحدين فما ثم إيمان محدث بل هو مكتوب في قلب كل مؤمن فإن زال في حق المريد الشقاء فإنما تزول وحدانية المعبود لا وجوده وبالتوحيد تتعلق السعادة وبنفيه يتعلق الشقاء المؤبد ولهذا الإشارة بقوله تعالى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا في الأخذ الميثاقي آمَنُوا لقول الرسول إليكم من عندنا فلو لا إن الايمان كان عندهم ما وصفوا به وأما نسبة الأعمال إلى هذا المنزل فهو على ما نقرره وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق أعمال وأحوال إضافية لأن الناس الذين هم محل مكارم الأخلاق على حالتين حر وعبد كما إن الأخلاق محمودة وهي التي تسمى مكارم الأخلاق ومذمومة وهي التي تسمى سفساف الأخلاق والذين تصرف معهم مكارم الأخلاق وسفسافها اثنان وواحد فالواحد هو الله والاثنان نفسك إذا جعلتها منك بمنزلة الأجنبي وغيرك وهو كل ما سوى الله وكل ما سوى الله على قسمين وأنت داخل فيهم عنصري وغير عنصري فالعنصري تصريف الخلق معه حسي وغير العنصري تصريف الخلق معه معنوي فالأعمال المعبر عنها بالأخلاق على قسمين صالح وهو مكارمها وغير صالح وهو سفسافها قال تعالى في القسم الواحد وعَمِلَ صالِحاً وقال في الآخر عَمَلٌ غَيْرُ صالِحٍ فَلا تَسْئَلْنِ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ من الْجاهِلِينَ فعلمه الأدب وإن من الأدب أن تسأل عن علم ما لا يعلم فإذا علم فإن كان من أهل الشفاعة والسؤال فيه سأل فيه وإن لم يكن لم يسأل فيه ولكن غلبت عليه رحمة الأبوة وهي شفقة طبيعية عنصرية فصرفها في غير موطنها فأعلمه الله أن ذلك من صفات الجاهلين والجهل لا يكون معه خير كما إن العلم لا يكون معه شر فقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يريد أنه يعلم ما هي وكيف تصرف وأين تصرف فلتعلم إن المخاطبين بها كما ذكرنا لك حر وعبد فللعبد منها شرب وللحر منها شرب فإذا أضفت الخلق إلى الله تعالى فكل ما سوى الله عبد لله قال تعالى إِنْ كُلُّ من في السَّماواتِ والْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمنِ عَبْداً وإذا أضفت الخلق بعضه إلى بعض فهو بين حر وعبد فأما حظ العبد من الأخلاق فاعلم إن السيد على الإطلاق قد أوجب وحرم فأمر ونهى وقد أباح فخير وقد رجح فندب وكره وما ثم قسم سادس فكل عمل يتعلق به الوجوب من أمر من السيد الذي هو الله بعمل أو ندب إلى عمل فإن العمل به من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك إن كان واجبا وإن كان مندوبا إليه فهو من مكارم الأخلاق مع نفسك فإن تضمن منفعة الغير ذلك العمل كان أيضا من مكارم الأخلاق مع غيرك وترك هذا العمل إذا كان على هذا الحكم من سفساف الأخلاق وكل عمل يتعلق به التحريم أو الكراهة فالتقسيم فيه كالتقسيم في الواجب والمندوب إليه على ذلك الحد فترك ذلك العمل لاتصافه بالتحريم أو الكراهة من مكارم الأخلاق وعمله من سفساف الأخلاق وترك العمل فيه عمل روحاني لا جسماني لأنه ترك لا وجود له في العين وأما العمل الذي تعلق به التخيير وهو المباح فعمله من مكارم الأخلاق مع نفسك دنيا لا آخرة فإن اقترن مع العمل كونك عملته لكونه مباحا مشروعا كان من مكارم الأخلاق مع الله ومع نفسك دنيا وآخرة وكذلك حكمه في ترك المباح على هذا التقسيم سواء فجميع الأقسام تتعلق بالعبد وقسم المباح يتعلق بالحر وقسم المكروه والمندوب إليه يتعلق بالحر وفيه من روائح العبودية شمة لا حقيقة فهذا قد حصر لك هذا المنزل منازل الشقاء والسعادة وأبانها لك معينة أي عينت لك من أين تعلمها وهو معرفة الشرع الذي أنت عليه فإن كان الإنسان ممن لم تبلغه الدعوة فمكارم الأخلاق في حقه ما قررها العقل من وجود الغرض والكمال وملاءمة المزاج كشكر المنعم الذي هو من مكارم الأخلاق عقلا وشرعا وكفر النعمة من سفساف الأخلاق عقلا وشرعا وما كلف الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها سواء بلغتها الدعوة أو لم تبلغها فإن للشرع في عملها حكما في نفس الأمر ويعفى عنه فيما أتته من سفساف الأخلاق حيث لم تبلغها الدعوة والعفو عن ذلك من مكارم الأخلاق الإلهية فالحق أولى بصفات الكرم من العبد بل هي له حقيقة وفي العبد بعناية التوفيق ومما يتعلق بهذا المنزل من المكارم التعاون على شكر المنعم والتعاون على تلقي البلاء من المبلى بأن لا يستند في ارتفاع البلاء عنه إلا لمن أنزله به وهو الله تعالى فإن أنزله بالغير فهو من سفساف الأخلاق وإن أنزله بالله كان من مكارم الأخلاق والعبد في الحالتين طالب رفع البلاء عنه والبلاء عبارة عن وجوده وإحساسه بالألم لا غير وفي هذا المقام يغلط كثير من أهل الطريق فيحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله فيما نزل بهم والشبهة في ذلك لهم أنهم يقولون لا نعترض عليه فيما يجريه علينا فإنه يؤثر في حال الرضاء عنه فيقال لهم قد حصل مقام الرضاء بمجرد إحساسه وعدم طلب رفعه وذلك حد الرضاء لا استصحابه فإن النفس كارهة لوجود الألم ولذا عبرنا عن البلاء بالألم لا بسببه وينبغي للعبد أن يسأل الله تعالى أن يرفع عنه ما نزل به لما يؤدي به إليه من كراهة فعل الله به ولا بد من كراهته طبعا لأن الألم يوجب حكمه لنفسه والفعل في إنزاله إنما هو لله فيتضمن كراهة الألم كراهته طبعا لأن الألم يوجب حكمه وجوده ووجود الألم لم يكن لنفسه وإنما أوجده الله في هذا العبد فتتعلق الكراهة حالا وضمنا بالجناب العزيز فلهذا وقع من الأكابر رب |